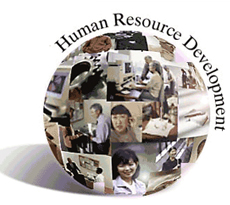 |
مقدمة :
لقد أحدثت التطورات التي شهدتها مجالات تقنية المعلوماتية والاتصالات نقلة نوعية أو ما يعرف بالتحولات العالمية التي أثرت في جميع العمليات التعليمية وبخاصة ما يتعلق بطرائق التدريس وأساليب التدريب.حيث أدت هذه التحولات إلى ظهور آليات حديثة في طرق اكتساب المعارف والمهارات وفي وسائل ونقلها واستراتيجيات توليدها. وأصبح من السهولة بمكان توظيف تقنية الاتصالات والمعلومات وتطويعها للحد من هوة الفوارق الاجتماعية والثقافية , وتخطي قيود الزمان والمكان وندرة الموارد البشرية.
ما هو التدريب الإلكتروني:
التدريب الإلكتروني يمكن تعريف بأنه العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب الآلي وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي تُمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خلال تفاعله مع مصادرها، وذلك في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود المكان والزمان .وأيضا هو تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر وسائط إلكترونية متنوعة تشمل الأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت بأسلوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التدرب الذاتي أو التدرب بمساعدة مدرب .
كما يعرف على أنه أي عملية تدريبية تستخدم شبكة الانترنت ( شبكة محلية ، الشبكة العالمية ) لعرض وتقديم الحقائب الالكترونية أو التفاعل مع المتدربين سواء كان بشكل متزامن أو غير متزامن أو بقيادة المدرب أو بدون مدرب أو مزيج بين ذلك كله.
ويعتبر التدرب عن بعد احد أنواع التدرب الالكتروني وهو عبارة عن العملية التدريبية التي يكون فيها المتدرب مفصولاً أو بعيدا عن المدرب بمسافة جغرافية يتم عادة سدها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. كما يمكن المتدرب من التحصيل العلمي والاستفادة من العملية التدريبية بكافة جوانبها دون الانتقال إلى موقع التدرب ويمكن المدربين من إيصال المعلومات والتفاعل مع المتدربين دون الانتقال إليهم كما انه يسمح المتدرب أن يختار برنامجه التدريبي بما يتفق مع ظروف عمله والتدريب المناسب والمتاح لديه للتدريب دون الحاجة إلى الانقطاع عن العمل أو التخلي عن الارتباطات الاجتماعية.
الفرق بين التدريب الإلكتروني والتعليم الإلكتروني
نقول انه لا يوجد فرق بينها من خلال بيئة التعليم الالكتروني حيث كلاهما يتطلب الأمور الأساسية في أي نظام تعلم الكتروني وكذلك نظام الفصول الافتراضية والية التسجيل والدخول , بينما يتجسد الفرق بشكل واضح وجلي في آلية تطبيق التعليم الالكتروني على الطلاب أو المتدربين ،حيث أن التعليم الالكتروني مرتبط بمسى المنشاة التعليمية (المدرسة و الجامعة ) يوجد مدرسين ويوجد طلاب واختبارات فصلية وحضور مميز وغيرها .ويطلب من المدرسين متابعة نشاطات طلابهم أثناء الفصل الدراسي من خلال نظام إدارة التعلم الالكترونيLMS ، وذلك باستقبال الواجبات والإجابة على الطلاب والتفاعل المباشر بين الطلاب والمدرسين من خلال الأنشطة التعليمية مثل الشات والمنتديات والويكي وغيرها.
بينما التدريب الالكتروني يستخدم لتدريب مجموعة من الأشخاص لا يتبعوا إلى منشاة تعليمية (تدريب موظفين ، تأهيل كوادر بشرية ) ويكون المستفيد من التدريب الالكتروني منسوبي الجهات الحكومية و المؤسسات الإدارية أو البنوك أو المنظمات الغير ربحية مثل (الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وما يترتب على التدريب الالكتروني هو آلية تطبيق التعليم الالكتروني للمتدربين ،هنا ما يسمى التعليم الذاتي وضبط دخول المتدربين إلى جميع محتويات المقرر الدراسي والتدريب بشكل جدي وفعال ، حيث لا يوجد هنا معلمين أو مدرسين يتابعون نشاطات المتدربين أو إجبارهم على حل جميع الأسئلة والمرور على جميع النشاطات الموجودة داخل المقرر ، وفي هذه الحالة يأتي دور تخصيص آلية عرض المقرر التدريبي بحيث يخضع إلى نظام إدارة الأنشطة التعليمية المتسلسلة (Sequence Activities ) وكذلك يجب أن يوجد نقاط عبور (Pass Points ) بين كل موضوع أي لا يمكن للمتدرب الانتقال إلى الموضوع أو النشاط التالي إلا إذا تحقق انه أنهى الموضوع السابق بشكل جيد ويمكن هنا وضع شروط أو خيارات لاجتياز المرحلة (مثلا اجتاز 60 % أو اقل أو أكثر وهكذا.
خلاصة :
كل المفاهيم التي نريد تطبيقها في التدريب الالكتروني هي من اجل ضبط دخول وحضور المتدربين واجتيازهم الامتحانات بشكل ألي بدون تدخل أي شخص من المدراء أو المعلمين ، حيث يتولى جميع هذه المهام هي آلية تطبيق تدريب المحتوى في نظام إدارة التعلم .وغير ذلك سوف يتطلب الأمر تكليف ما يقارب 50 معلم لمتابعة 5000 متدرب , بينما هنا تتم الأمور كلها بشكل آلي إلى أن يحصل على الشهادة الالكترونية (شهادة حضور ، شهادة درجات أو معدل )ويقوم الآن فريق التعليم الالكتروني في مؤسسة الأسلوب الذكي بتطوير هذه التقنيات من خلال نظام MOODlE لتكون أول خدمة في التعليم الالكتروني بهذا المستوى في العالم.
أهمية التدريب الإلكتروني وأهدافه :
أهميته:- المتدرب هو المتحكم في العملية التعليمية أما المدرب فيكتفي بتوجيه المتدرب.
- المتدربين مشاركين في العملية التعليمية (تدرب إيجابي).
- يمكن للمتدرب أن يصل للحقيبة التدريبية في الوقت والزمان المناسبين له.
- ينشئ التدرب الالكتروني علاقة تفاعلية بين المتدربين والمدربين
- استخدام كل ما هو متاح من وسائل مساعدة واستخدام أنماط تدريب مختلة.
- تقليل تكلفة التدرب ورفع كفاءة المتدربين
- يقلل من تكلفة السفر للمتدرب والمدرب
- يشجع المتدربين على تصفح الانترنت من خلال استخدام الروابط التشعبية للوصول إلى معلومات إضافية حول موضوع الدرس
- يطور قدرة المتدرب على استخدام الحاسب والاستفادة من الانترنت مما يساعده في مهنته المستقبلية
- يشجع المتدرب على الاعتماد على النفس والوصول إلى مرحلة بناء المعرفة ذاتياً
- زيادة ثقة المتدرب في نفسه
- سمح للمدربين بتطوير المادة التدريبية باستخدام المصادر الالكترونية والانترنت
- يسمح للمدربين بالاحتفاظ بسجلات المتدربين والعودة لها في أي وقت ومن أي مكان
- الوقت والمنهج والتمارين تعتمد على مستوى ومهارات المتدرب وليس على معدل المجموعة. فالمتدرب الأقل مستوى لديه وقت لرفع مستواه والمتدرب المتميز يستطيع التقدم دون انتظار المتدربين الأقل مستوى .
- معرفة معنى أو مفهوم التدريب الإلكتروني .
- مساعدة المتدربين على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والشبكات المتاحة للتعلم الإلكتروني لدراسة البرامج والمناهج والمقررات التدريبية ومراجعتها .
- تصميم برامج التدريب ومناهجه ومقرراته بطريقة رقمية .
- إعداد المتدربين للحياة في عصر الثقافة المعلوماتية .
- التغلب على مشكلات أساليب التدريب التقليدية .
- معرفة الأسس والمعايير التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات لتطوير منظومة التدريب .
للتحول من التدريب التقليدي إلى التدريب الإلكتروني، ينبغي مراعاة ما يلي :
1- التخطيط لنظام التدريب:
إن عملية التخطيط لنظام التدريب هي مسؤولية العديد من الجهات المستفيدة منه في المقام الأول، وييسر تلك العملية وجود المتخصصين في التدريب، وأساتذة الجامعات والكليات، وخبراء التقنية. حيث لم يعد التخطيط للتدريب يتم بمعزل عن الكثير من الجهات. كما أن التخطيط له لم يعد يتم بمعزل عن توجهات الدولة وخططها التنموية المختلفة، لاسيما أن أنظمة التدريب المستقبلية أنظمة مفتوحة يساهم فيها المجتمع المحلى. ويدخل ضمن التخطيط لمنظومة التدريب أيضاً تقدير الحاجة إلى التدريب الإلكتروني، وتحديد الأهداف العامة والخاصة له.
2- تنفيذ التدريب:
ويقصد به الكيفية التي يتم من خلالها ترجمة السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم وصفها في مرحلة التخطيط لتحقيق الأهداف الموضوعة للتدريب. ويرتبط بتنفيذ التدريب تكوين فريق التدريب الإلكتروني، الذي يتكون من :
- بعض مديري إدارات التدريب .
- مصممي البرامج التدريبية .
- مجموعة من الفنيين في مجالات: تقنية المعلومات، والبرمجة، والشبكات، وأمن المعلومات الذين تتكامل جهودهم مع الفنيين الأكاديميين والتربويين .
ويتضمن التنفيذ اختيار البرامج المرتبطة بالتدريب الإلكتروني أو إعدادها، وتطبيق تقنيات التعلم والتدريب، واستخدام الأجهزة والبرمجيات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في التدريب الإلكتروني، وممارسة كافة الأنشطة التدريبية الإثرائية ومنها حضور المؤتمرات التي تهتم بالتدريب الإلكتروني .كما يتضمن التنفيذ أيضاً تحديد احتياجات المتدربين وتقديرها للعمل على إشباعها، والدعم الفني مثل الاتصالات وتصميم وإعداد البرامج التدريبية للوفاء بالاحتياجات المرجوة من التدريب .
3-تقويم التدريب الإلكتروني
تستند عملية تقويم التدريب على عدد من الأسس والمعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات لتطوير نظام التدريب، ورسم استراتيجياته المستقبلية، ومن هذه الأسس والمعايير ما يلي :
- تحديد أهداف التدريب القريبة والبعيدة ووضوحها .
- شمول عملية التقويم واستمراريتها .
- ترابط عناصر منظومة التدريب واتساقها .
- تكامل جهود التدريب السابقة واللاحقة وجودتها .
المصدر: ادارات نت















